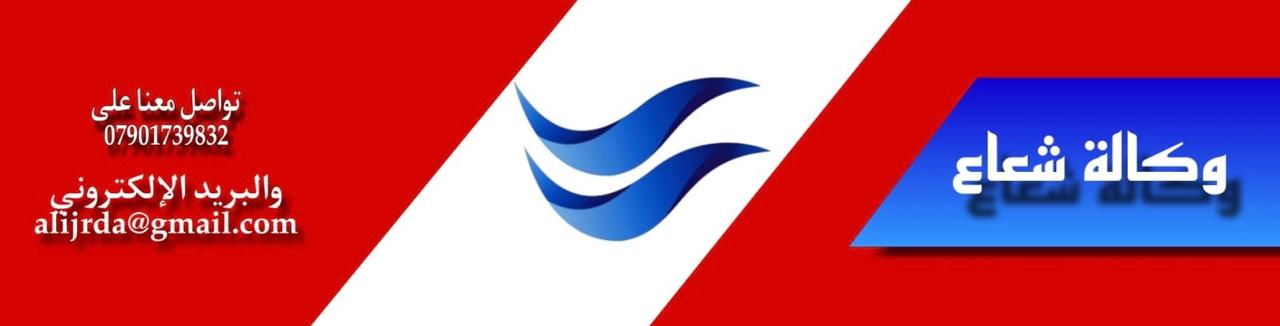أنصار الحسين: الوعي الرسالي وتحوّل الفرد إلى مشروع شهادة محمد علي الحيدري

أنصار الحسين: الوعي الرسالي وتحوّل الفرد إلى مشروع شهادة
محمد علي الحيدري
ليست واقعة كربلاء مجرد صفحة دامية في سجل التاريخ الإسلامي، بل هي نقطة تحوّل فلسفي في فهم الإنسان المؤمن لدوره، حين يرتقي من خانة “الرعية” المنفعلة إلى مقام “الذات الرسالية” التي تختار الوقوف في صفّ الحق مهما كانت الكلفة.
وفي صلب هذه اللحظة الاستثنائية، تبرز شخصيات أنصار الإمام الحسين عليه السلام، لا كأسماء مكرّسة في المرويات، بل كنماذج بشرية فريدة بلغت ذروة الوعي، حتى صارت الشهادة عندها فعلًا معرفيًا، وموقفًا عقلانيًا، وانتماءً عقائديًا متكاملًا.
هؤلاء الأصحاب لم يكونوا جنودًا مأمورين، ولا قومًا قادهم الحماس العاطفي إلى مذبحة محسومة، بل أفرادًا وازنوا بعقولهم بين الحياة والمبدأ، وخرجوا من الامتحان وقد حسموا خيارهم لصالح المعنى لا المصلحة. في زمن اختلط فيه الدين بالسلطة، وتحوّلت الخلافة إلى مُلكٍ وراثي، تميّز أنصار الحسين بقدرتهم على اختراق ضباب الفتنة، والتمييز بين خلافةٍ زائفة تفرضها القوة، وإمامةِ حقٍّ يمثلها ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لم يكن انحيازهم له خضوعًا لقرابة، ولا انتسابًا عشائريًا، بل استجابة لنداء الحقيقة المتجسّدة في رجلٍ رفض مبايعة طاغية، وقال كلمته الخالدة: “مثلي لا يبايع مثله”.
في شخصياتهم، تتجلّى وحدة نادرة بين الوعي والشجاعة. فمنهم الشيخ المسنّ كحبيب بن مظاهر، ومنهم الشاب كالقاسم بن الحسن، ومنهم الفتى اليافع كعبد الله بن الحسن، ومنهم العبد المُحرَّر كجون، ومنهم المسلم غير العربي كوهب النصراني الذي أسلم وآمن وتقدّم القتال، ومنهم الرضيع عبد الله بن الحسين، الذي حمله أبوه إلى القوم يستسقي له، فجاءه السهم بدل الماء. لم يكونوا كتلةً متجانسة، بل فسيفساء إنسانية موحّدة بالرؤية والغاية. لم تجمعهم طبقة اجتماعية، ولا لغة واحدة، بل جمعهم المعنى: أن الحق لا يُترك، وأن الإمام الحق لا يُخذل.
وقد تجلّى هذا الوعي بأسمى صوره في ليلة عاشوراء، حين خيّرهم الإمام بين البقاء والانصراف، وأطفأ السراج حتى لا يحرج أحدًا منهم، بل حثّهم على الانصراف إن أرادوا، قائلًا: “إن القوم لا يريدون غيري”، ومع ذلك، لم يغادر أحد منهم. لم تكن بيعتهم للحسين بيعة مصلحة، بل ميثاقًا وجوديًا لا يُفسخ. أجابوه بما يليق بوعيهم: أن الحياة بلا حقّ ليست حياة، وأن البقاء مع الباطل هزيمة قبل القتل. كانوا أحرارًا في قرارهم، واختاروا، بملء إرادتهم، أن تكون كربلاء شهادةً للحق، لا لحظةَ نجاةٍ فردية. وهكذا، أثبتوا أن الإمامة لا تكتمل إلا بأنصارٍ يشبهون الإمام في الوضوح، واليقين، والوفاء.
لقد كانت كربلاء امتحانًا للفرد لا للجماعة. كلّ واحدٍ منهم قاتل لا لأنه تلقّى أمرًا، بل لأنه اختار بإرادته الحرة أن لا يكون تابعًا لزيف، ولا شريكًا في صمت. من خذلوا الحسين لم يكونوا جميعًا من المنافقين أو أعداء أهل البيت، بل من العاجزين عن كسر حاجز الخوف، أو من الملتبسين الذين خضعوا لمنطق الطاعة للحاكم وإن جار. أما أنصاره، فكانوا القلّة التي اخترقت هذا الحاجز، وارتقت فوق حسابات النجاة، حتى أصبحوا رمزًا دائمًا للفرد الذي يعلو فوق الجماعة حين تُضلّ، وللموقف الذي يسمو على العُرف إذا انحرف.
لقد تحوّلت كربلاء بفضلهم إلى لحظة تأسيس سياسي من نوع خاص، لا تُقاس بميزان الغلبة، بل بميزان الرمزية والخلود. لم يُهزَم الحسين حين قُتل، بل هُزِم يزيد حين انكشف، واهتزّ عرش السلطان حين وقفت حفنة من المؤمنين بوجهه، لا يملكون جيشًا ولا دعمًا ولا دولة، بل إيمانًا نقيًا ويقينًا نادرًا. ولعلّ في قول زهير بن القين ما يكشف عمق هذا الوعي، حين قال: “والله، لوددت أني قُتلت ثم نُشرت، ثم قُتلت، حتى أُقتل هكذا ألف مرة، وأن الله يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتيان من أهل بيتك”. إنها شهادة عقل، لا شهادة عاطفة.
أنصار الحسين لم يكونوا مجرّد شهداء، بل خلاصة رؤية: أن المشروع الرسالي لا يُبنى بالأكثرية، بل بالوعي، وأن الإصلاح لا يتحقّق بالعدد، بل بالموقف، وأن الإنسان حين يرتقي في فهمه لمسؤوليته، يتحوّل إلى كائنٍ سياسي من طراز أخلاقي وروحي رفيع، لا تغريه السلطة، ولا يخيفه القتل، ولا تُقيّده أنصاف الحقائق.
وفي زمن الانهيار المعنوي، حين تُختزل السياسة في الصفقات، والدين في الطقوس، يصبح استدعاء أنصار الحسين استدعاءً لفكرة الإنسان الحر، الذي لا يساوم، ولا ينتظر جمهورًا يصفّق له، بل يكتفي بأن يكون صادقًا مع ضميره، مستعدًا أن يفنى ليبقى المعنى.
فهم، بكل بساطة، المثال الأعلى للفرد الذي وعى الله، والحق، والعدالة، فتحوّل إلى مشروع شهادةٍ حيّة، لا تنطفئ ما بقي الضمير الإنساني قادرًا على تمييز النور من الظلمةي